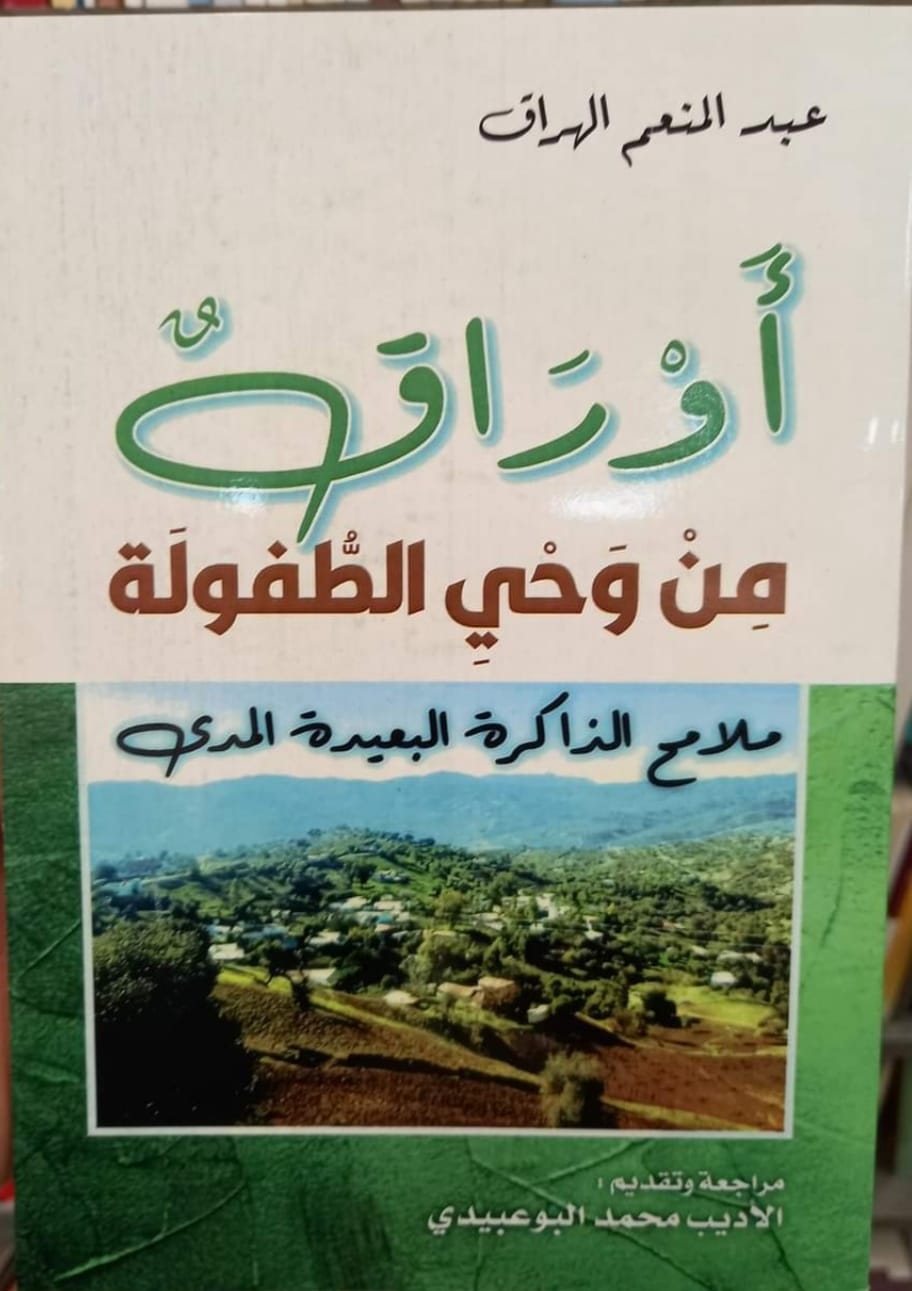*قراءة الدكتور الصديق الدهبي.
تَجْذُب الأراق دوما ناظريها، إنها ساحرة آسرة، مفعمة بالحياة والروح، وإذا ما ارتفعت طالت خضرتها الجميع، بل حتى في نهايتها هي لا تموت بل تذبل وتتراخى، لتسقط على هيئة رقصة في ثنايا الريح متوسدة في لحظة وصولها للأرض روح التراب، مانحة لقحالتها زينة خجولة مؤقتة في انتظار عودة الأوراق إلى شغفها وهي تكسو الأشجار معلنة ميلاد الربيع. تلك باختصار قصة الأوراق المعبرة عن مفارقات الوجود وثنائيات العيش ومراوحات الذاكرة، أكانت أوراق الشجر أو أوراقا لتدوين التاريخ والذاكرة وشظايا الأمس وشذرات القول، وهذا مقصد الكاتب “عبد المنعم الهراق” في روايته “أوراق من وحي الطفولة” التي صدرت مؤخرا بمراجعة وتقديم الأديب “محمد البوعبيدي”، وهي لرجل عاشق للأوراق، عاش كُتبيا يجول في حضرة النصوص وتَلَمُّس الصفحات ومداعبة الكتب.
إنها “أوراق” تحكي تاريخا مجيدا لجزء من شمال المغرب، الواقع على تخوم سلسلة جبال الريف المُرصعة بدروس التاريخ، حيث تتربع قبيلة بني زروال على عرش تلك القمم الشامخة بعزة ماضي أهلها، لكنها مع ذلك أوراق ترفض الانصياع كليا لوصايا “رولان بارت” في دعمه لممكنات زواج الرواية والتاريخ، حين تمتنع عن السرد باعتباره تأريخا وتتوجه بالمقابل صوب إبراز ثنائيات ومفارقات الوجود في حدوسه البسيطة، إنها أكثر من كونها تجربة في الحكي وامتحان الذاكرة، بل هي دليلا وبيانا في العرف والأخلاق والتقاليد، ومدخلا للتعريف بعز القرية والقبيلة وروحها المبتلة بثنائيات الزمن ومنزلقاته.
وهكذا تكون أولى دروس الرواية، هي استحضار مسيلات الذاكرة وإجبارها على قول ما بقي في الروح مخبأً، من خلال التعويل على الكتابة بنَفَس شذري ليس قصده الانطلاق بالحكي والسرد من نقطة بداية إلى أخرى تكون المنتهى كحال السِّيَر الشبيهة، بل أراد اختزال لقطات الذاكرة كما راودت مدون “أوراق من وحي الطفولة”، وكأنه رافض لفكرة إجبار ذاكرته هذه التي تصف نفسها بالبعيدة من الاقتراب عنوة من الأحداث؛ يريدها أن تبوح هي بنفسها لا أن يُقَوِّلها هو ما يريد، وذاك سبب سلكه درب التدوين السريع والكتابة على أوراق مشتتة لا تلمها أسلاك تنظمها.
فهو يكتب عن الطفولة وأيام الدراسة، ثم يتجول في ذاكرة الأمكنة ويتنزه في وصف أسواق القبيلة ومراعي القرية ومزارعها، وينتقل بعدها إلى سرد قَصَص الشباب وحكايات الحب والتودد والغرام في قصة “زهرة” الشابة بعيون تاء التأنيث، و “مرجان” الشاب العاشق من زاوية ذكورية، وكأن قصده الحديث باسم هموم أهل البلد وذكرياتهم وترنيماتهم الوجودية وحالهم الخفي والظاهر، نساءً كانوا أو رجالا، صبيان أو شبابا، كهولا أو شيوخا، يُنصت لسَجِيَّتِهم بلطف كمن يلملم شتات ورق الذاكرة الجمعية، لا ككاتب يروي عنهم ما يراه هو، يجبرهم على دفعه للكتابة لا أن يلزمهم بالبوح.
ثم يُقَلِّبُ النظر صوب ثاني الدروس، حين يلم “شتات الزمن” في دائريته “المُقدسة”، حيث انعدام البداية والنهاية، واكتمال الشكل والتشكل، لكن دون سلك درب التعريف بدائرية هذا الاكتمال علميا، وإنما عن طريق التعريف بهذه الدائرة الدائمة والمستمرة للزمن حسب عُرْف القرية ومخيال أهلها، على شكل حلقة يحتكم إليها الوجود الفردي والجماعي، الذي يمر من لحظات ثابتة لكنها متحولة في الآن ذاته، فهو ينتظر نزول حبات المطر إعلانا ببداية الحياة، ثم يتوق إلى زمن جني الزيتون بكل دلالاته وسماته، ويتوجه صوب تجريب امتحان تطويع الأرض وحرثها، والعناية بالمحاصيل ومراقبتها والحرص على ضمان استمرار نضجها، وصولا إلى مرحلة جني الثمار وحصاد الخيرات ونقلها عبر الدواب إلى البيدرلا وما يليها؛ إنه يصف في النهاية رحلة العمر ودائرية الزمن من لحظة الشتاء والبرد القارس إلى الصيف وعذابه الشديد، من قطرة الحياة إلى لحظة الموت والحصاد، مختصرا مسارات الحياة في نظر أرسطو وهي تنتقل من “الكون” إلى الفساد”.
هي حلقة ودائرة عند الناظر لها من خارج أسوار البلد مجرد سلسلة زمن، لكنها في أعراف القرية وأناسها تقليد دائم وعادة مُقدسة تختفي معها حسابات الزمن وثقل السنين، ما دام أمر الإبقاء على دوام نفس المبادئ حاضرا، فالذي يدوم هو معدن الناس وتعاقب أفراحهم ومعاناتهم، ودوام حال ثنائياتهم جيلا بعد جيل، وهذا درس ثالث من دروس هذا العمل الإبداعي الذي صاغه الكاتب “عبد المنعم الهراق”، حيث التعبير بروح بديعة في وصفه ورؤيته لحال القرية، ذلك المكان المليء بالصفاء والطهارة والعذرية والمحبة والتضامن، والمحكوم بمنطق التعب والقسوة والمعاناة وضيق الحال؛ والحق أنه حال القرى جميعا حيث لقاء المتناقضات وزواج الثنائيات، فهي موطن “الشقي والسعيد” لا في حياة “بِشْر” و “الحُسين” وإنما في حال عموم ناسها وأهلها، وجميلها أن لا اختلاف بين أهلها ولا تراتب ولا طبقية، ذلك أن موازناتها وتناقضاتها ومفارقاتها وتبدل حال ساكنيها وأحوالها يسري على الجميع، إنها درس في المساواة وهي توثق لحالة توزيع البؤس والظلم والفرح والطيبة بعدالة فائقة؛ هي في النهاية موطن “الشقاء والسعادة” و “الحزن والتضامن” و “الشدة والرخاء” و “العظمة والبؤس”.
ثم إن الرواية تقترح من جهة رابعة، وجها مغايرا للتاريخ، فهي رغم رهانها على حفظ الذاكرة الجماعية كمبتغى، إلا أنها تتوجه نحو هذه الغاية بوهج أصيل حينما تتجاوز صرامة التأريخ وقواعد الجغرافيا ومناهج الأركيولوجيا؛ إنها تُعَرِّفُنا في هذه الحالة مثلا على نفس ميزات قبيلة “بني زروال” ومداشرها وأعرافها وتقاليدها وأفراحها وأحزانها الموثقة في كتب التاريخ ومطبوعات الجغرافيا وأبحاث السلف، لكنها تقوم بهذه المهمة بروح جديدة تستقصي خلالها هواجس الناس وطموحاتهم، وتتحدث لغتهم اليومية بأحاسيسها ومشاعرها، تدق أبواب العيش البسيط وتفتح نوافذ الحياة العادية الأصيلة في بداهتها، هكذا يصف تجربة “السوق الأسبوعي يوم السبت” مثلا، لكن دون إشارة لإحداثياته وتاريخ نشأته وسلعه وقيمة مبيعاته ولا لباقي التفاصيل المعنية برهان التكميم الرياضي والتدقيق العلمي، بل قصده وصف أحاسيس الصبية وهواجسهم الطفولية، حين يصف كيف أن “البحث عن الأهل والأحباب في زحام السوق المليء بالغبار ضروري جدا لزيادة رصيد المصروف الأسبوعي”، أو في سرده لطقوس الاستعداد لاستقبال السبت الموعود وغيرها عند الكبار والصغار، للحديث عن تلك الكومة الممتلئة بالأحاسيس، حتى إذا وضع أحدهم عليها عينه وتصفح كلماتها وجد نفسه فيها وكأن الرواية تستقصده وتتوجه إليه.
وخامس الدروس وأبلغها؛ يكمن في تمجيد روح البلد، حتى أنه إذا ما وصف ضيق الحال وقسوة الحياة وشدة المقام، انتهى كلامه وهو يتغنى بالنهايات السعيدة، وكأنه يقول أن القرية هي رمز الشدة والتحدي لكنها موطن النجاحات والانتصارات، يَنقم ويُعاتب تقاليدها وأعرافها متحدثا حسرة “زهيرة” حين منعتها حسابات السلف من تتمة نور علمها، قبل أن يُحول دفة الحديث إلى نجاحها وشجاعتها حين أنجبت جيلا مستنيرا بوهج العلم وسراجه، واصفا كيف أن فصلها عن الدراسة مبكرا لم يكن سوى دافعا لطي صفحات الجهل والخنوع وفتح أبواب “النور إلى الأبد”، ثم يُقلب الكفة ويعكس المعادلة لوصف حال “رفيدة” التي بدأت مشوارها بالعز والسؤدد وانتهت بعزاء وحسرة شديدتين، ومغزاه فتح أظرفة تقلب الحال في تلك القرى البسيطة الموجودة على هامش رؤانا، معترفا بأن القاعدة في عرف القرية هي انتفاء القواعد، فالسعيد يُمسي شقيا والسؤدد ينتهي حزنا وهكذا.
في النهاية “عبد المنعم الهراق” ضمن أوراقه يصف ويحكي لا لكي يوثق، بل لكي يدفع أي قارئ للعيش في حروف الرواية وألفاظها وعباراتها وجملها، خاصة ممن خبروا هذه القرى والقبائل والمداشر، وقصده أن يكون كلامه اعترافا وإحياءً للذاكرة حين يُمجد “عمي قربوز” ويُثني على “الفقيه” و “المُدرس”، معاتبا حياة “المدينة” وبهرجتها، ومعترفا بسماحة وعدالة وصدق نية “عمي حميدو” بائع الزيت، بل يتعداه إلى مستوى الإنصات للدواب واصفا وفاء “البغل مبروك”، معبرا عن واحدة من جواهر حياة البادية حيث تلاقي الحياتين: حياة الناس والدواب، وارتباطهما الشديد كأوراق متشابهة إذا ما مُثِّلت القرية بشجرة؛ وهكذا تُمسي الرواية هي بحق أوراق كُتبت لا لكي تُوَثَّق بل لكي تُوَثِّق، وتلك الطفولة نداولها بين الناس.