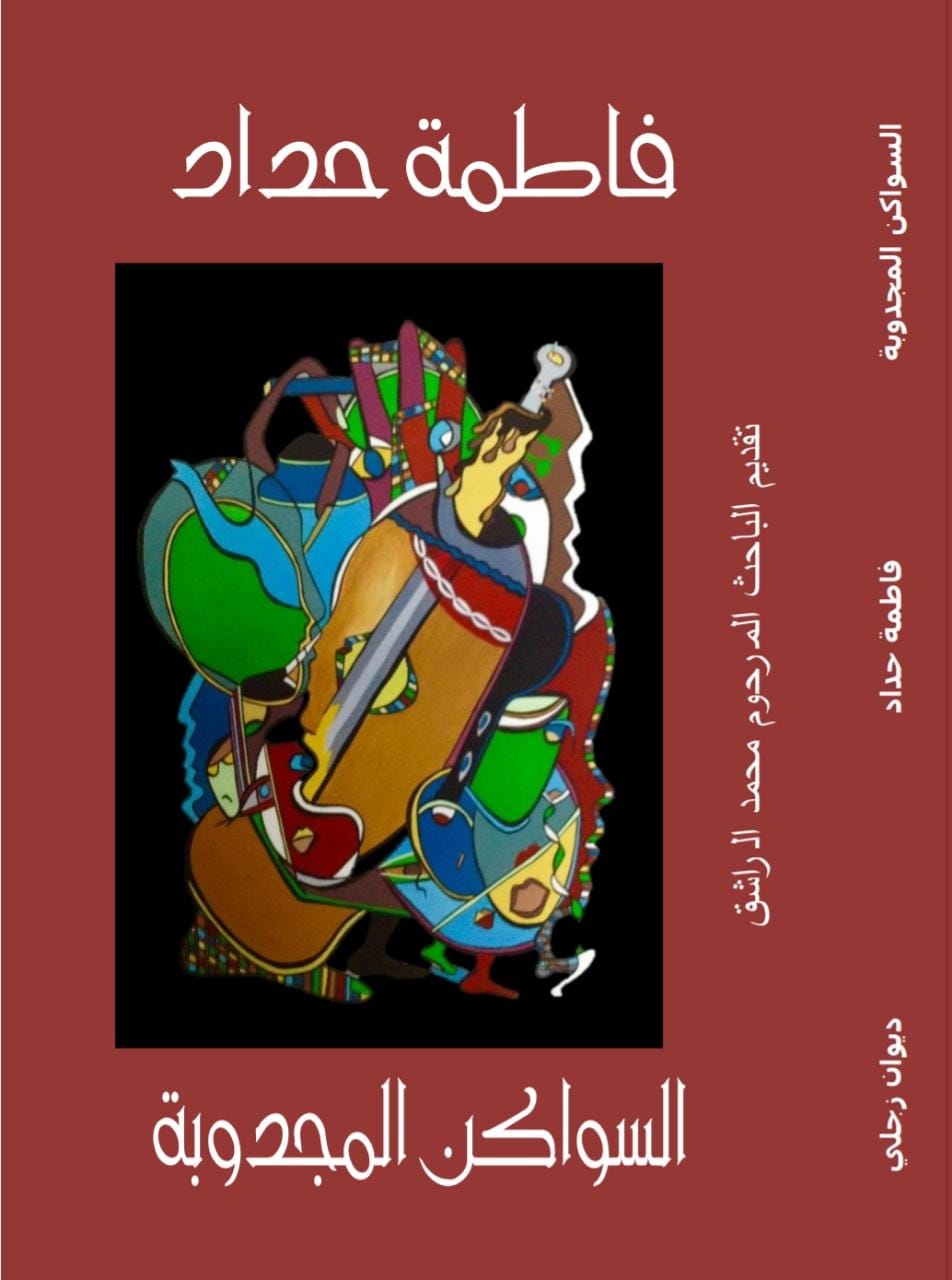**بقلم عز الدين المعتصم
يعد التراث الشفهي بالمغرب إبداعا إنسانيا عريقا يقوم على طقوس كلامية تتصل بالحياة اليومية، وترسم في غناها وتنوعها العديد من الدلالات والمعاني الرمزية التي تنمو وتتحول داخل وجدان جمعي مشترك، وفي عمق هذا التراث تشتغل مجموعة من الأشكال الشفهية على الذاكرة واللسان بوصفهما يشكلان الحافظة الجمعية التي بات الاعتماد عليها أمرا ضروريا لصون هذه الإبداعات القولية، في غياب حركة تدوين حقيقية قادرة على تحويل الخطاب اللساني من مجال التداول الشفهي إلى إطار التلقي المكتوب. ومن هذا المنطلق تهدف هذه الورقة البحثية إلى التأكيد على القيمة النوعية التي اكتسبها الزجل المغربي من خلال رصد تجليات الجذبة الصوفية وملامح اشتغال تيمة المرأة في ديوان “السواكن المجذوبة” للشاعرة فاطمة حداد.
الجذبة الصّوفية
كثيرا ما تبادر إلى ذهن كثير من الباحثين والدّارسين أن الزّجل المغربي بمثابة شعر وضيع مبتذل ورخيص، بيد أنه يُسْتَوحى من الشعب على اختلاف طبقاته، ويفيض بروحه ويعبر عن ذوقه ومشاعره، ويصور مستوى حياته ويظهر ثقافته. فهو الشعر الذي يصور طقوس الحياة في جوانبها الاجتماعية والسياسية بصورة يغلب عليها طابع التعميم والنزوع الأخلاقي. وعلى هذا الأساس يشكل ديوان الزجل “السواكن المجذوبة” للشاعرة فاطمة حداد ملمحا صوفيا يفصح عن الوجدان الجمعي للمغاربة. ويشير عنوان “السواكن المجذوبة” إلى “أصحاب الحال” هذه الجملة التي تحيل في اللهجة المغربية على أصحاب المس أو الدراويش أصحاب الكرامات والنّيات الطيبة في سذاجة، الذين يغدون من “مّالين الحال” أي أصحابه، ويطلق على الأولياء الذين يخضعون لتأثيرهم لقب “الأجواد” وهي التّسمية التي تحمل في العرف القبول والإيمان والبركة. وترتبط الجذبة بمفاهيم أخرى، مثل : (الجلالة – الحال – الحضرة – الخلوة)، ويشير الجذب في اللغة إلى الجلب وشد الشيء إلى غيره. وتعتبر مفاهيم: الجذبة والجلالة والحال والحضرة والخلوة، في كليتها ممارسات ومراتب دينية وطقوس صوفية، يجاهد من خلالها المتصوفة للوصول إلى المعرفة الصوفية والمحبة الإلهية، كما تشير إلى ذلك الأستاذة حنان بندحمان في دراستها الموسومة بتجليات الجسد في الكتابة الشعرية المغربية المعاصرة. تقول الشاعرة في قصيدة “السواكن المجذوبة”:
السْواكنْ مَجْذوبَة
والعْلامْ فيه سَبْعْ لْوَانْ
العْقَلْ خارجْ عَلْحوَالْ
والكَسْدة مزقة بلمْحانْ
هدا يتْحيّر تَحْيارْ
على السّعْد لِّي خَابْ
هدا يجْدب جدْبَة
على المِيمُونْ والمكْتابْ (ص. 31)
يقصد بالجذب عند المتصوفة كل ما يبدو على القلوب من أنوار الهداية، على مقدار قرب الإنسان وبعده وصِدقه وصفائه من وجده. وتطلق العامة كلمة “المجذوب” على السائح ذي الكرامات والمناقب، تجري على لسانه مجموعة من الحِكم منثورة في عدَّة موضوعات، وأغلبها من تجارب الحياة كالرّباعيات عن الشيخ عبد الرحمان المجذوب، حسب الباحث عبد الرحمان الملحوني. وتقول الشاعرة فاطمة حدّاد في هذا المعنى:
هَدا حَالْ الّلي مجْدُوبْ
ديمَا هَايمْ ومسْلوبْ
ودْوَاخْلُه ما تهْدَى
منْ حضْرَة لْحضْرَة (ص. 33)
يتضح من خلال هذه الصورة الشعرية أن المجاذيب قوم لهم أمور غريبة، وأفعال عجيبة، ولهم تصرّفات شادّة ظهروا في القرنين: التاسع والعاشر للهجرة. فكانت لهم مجالسهم وآراؤهم، ومعظمهم قد يكون مصابا بأعراض نفسية أو مرضية، أو يكون عنده استعداد خاص ليوهم الناس، ويلقي في روعِهم ما يهيمن على مشاعرهم ونفوسهم، فيجلّونه ويحترمونه، بل كان جلّ العوام البسطاء يجعلون من هؤلاء ملاذا أمينا يلوذون إليهم عند المَلمَّات، وعند عجزهم بصفة نهائية، بتعبير الأستاذة حنان بندحمان. تقول الشاعرة:
البْخُورْ فالسْمَا مْشَابكْ
يكْتبْ حْرُوفْ الرَّحْمن
ها الجَّاوي هَا حصْلَبانْ
هَا لِّي فيهْ الحَالْ يْبَانْ (ص.32)
يتنفّس هذا المقطع بمصطلح “الحال” لدى المتصوّفة، إذ كان العامّة يُطلقون على المجاذيب أسماء متعدّدة، منها “أهل الله” و”أصحاب الحال”. فيقولون: دَخَلَ مَعَ أَهْلِ الحالِ، أي مَعَ أَهْلِ الجَذْبَةِ الصوفية. فضلا عن هذا كله، يستعمل مصطلح المجذوب رديفا لمصطلح “البوهالي” الذي يرتبط بالجنون كمرض عقلي، ومن ثمة، لا يعتد بكلامه، وهو في ثقافتنا المغربية يستعمل بمعنى قدحي للشخص الذي فقد صوابه. فهو الذي يحضر بدربالته كشخصية رافضة لما هو قائم في المجتمع، ساخرة مما ألِفه الناس، لهذا قد يأتي كلامه غير مفهوم وشبيه بالهذيان. وهذا المعنى يتّضح بجلاء في الصورة التّالية:
بْحَالْ النّارْ إيلا توقَادْ
تغْلِي تدوّبْ لجْسَادْ
والسَّاكنْ ساكنْ مجْنونْ
بَاحْ ما كتمْ وفْشَى المكْنُونْ
بَاحْ بالنِّية والمضْنُونْ (ص. 32)
لقد شاع في الفكر الصّوفي أن الواقف بباب الصالحين، يأتي وقد أخذ به العطش الروحي مأخذه القاتل، وأصبح يكابد لواعج الأدواء والعلل، وبالمناجاة والتضرع، يوصف للمريض جرعات من الدواء الصوفي، فيغيب عن العالم المادي لينجلي له النور الإلهي، وهذه هي أحوال المتصوفة التي قالت عنها الشاعرة في قصيدة “الساكنني”:
دِيكْ لِّي فِيا
حَالْفَ بحْلُوفْ القسْمِية
لَتْحَمّقْني ..
لتْهَبّلني ..
حتى تبْقى فاهْيا فِيا
عدوتِي منِّي
رايْدانِي نَارْ مطْفِيّة
تنْفخْ فرْمَادِي
وتزْهرْ منِّي جمْرَة
تكْوِي دْوَاخْلِي
والِّلي بَاقِي فِيا .. (ص. 114)
نستنتج أن لغة الزجل، وإن كانت تندرج ضمن الأدب الشفهي، فهي شأنها شأن اللغة الشعرية عامة، تنحو إلى الغموض والتغريب بناء على ما تنشئه من علاقات قائمة على الانزياح اللغوي.
موضوعة المرأة
انعكست صورة المرأة في الشعر العربي، فقد تفنن الشعراء بالقول فيها، واختاروا لها أجمل الألفاظ ووظفوها في قصائدهم وأطالوا فيها إرضاء لنوالها، لأنها خمرة الشعر ورحيقه، يرتشفه الشاعر فتأخذه نشوة، بل خطفة عقلية وما ينتبه منها إلا وفي فمه لحن سماوي، يتذوقه القارئ. وقلّ أن ترى أدبا رفيعا مجردا عن ذكرها، ففيه من روحها حلاوة، ومن دلالها نغمة، ومن غنجها رقّة، ومن فتور عينها هيمنة. ومن هنا، أذكت المرأة جذوة الإبداع الشعري وحفَّزت الشاعرة فاطمة حداد على إنتاج عمل إبداعي متميز في خصوصيته البنيوية. وهكذا وجدناها تعبر عن تمرد المرأة على الهيمنة الذّكورية السائدة، وتطلق صرخة مدوّية في وجه المجتمع الذي تهيمن عليه التقاليد البالية التي تحظّ من شأن المرأة. تقول الشاعرة في قصيدة “ياك احنا خاوة”:
المْرَا شُوكَة ومْرَارْ
فْحَلقْ كُلْ منْ هُو حَگَارْ
وبْغَا يْخَلِّيها للاقْدَارْ
تْعُومْ فْمواجْ بلا مجْدافْ
لكن المْرَا مْرَا حرَّة
تْعاندْ ما تحْسدْ
حُرَّة لغْيادْ (ص. 100- 101)
تجابه الشاعرة كل أشكال البغي وتناهض مختلف ألوان الظلم التي تنقص من قيمة المرأة، وفي المقابل تجمّلها بصفة الجمال؛ إذ يعد الجمال مقاما من مقامات التّصوف. وقد أشار أبو القاسم القشيري في “الرّسالة القشيرية” إلى أن المقام هو ما يتحقق به العبد بمنازلته من الآداب مما يتوصل إليه بنوع تصرف ويتحقق به بمقاساة وتكلف، فمقام كل أحد، موضع إقامته عند ذلك، وما هو مشتغل بالرياضة له، وشرطه أن لا يرتقي من مقام إلى مقام آخر، ما لم يستوف أحكام ذلك المقام، فإن من لا قناعة له لا تصلح له الإنابة، ومن لا وَرع له لا يصح له الزهد. والمقامات هي المنازل الرُّوحية التي يمر بها السالك إلى الله، فيقف فيها فترة من الزمن مجاهدا في إطارها، حتى يفضي سلوك الطريق إلى المنزل الثاني، لكي يتدرج في السمو الروحي من شريف إلى أشرف، ومن سامٍ إلى أسمى. ومن ثمة، فإنّ الجمال مَلَكَة طبيعية، تتكشف من خلال لحظات نادرة من الوعي المتعالي، ونقصد أن الجمال وليد الإلهام كما هو الحال عند الشعراء، والإشراق كما هو الحال عند المتصوفة، ومن الحدس كما هو معروف عند الصنَّاع وغيرهم من أرباب الحرف والمهن. أما الجمال عند الشاعرة فاطمة حدّاد فيتجسد في كون المرأة تمثل أتَمَّ وأكمل تجلٍّ للألوهية حسب محيي الدّين بن عربي. ذلك أن الإبداع لا يتحقق إلا لأنه يحمل داخل إمكانية التلقي، والعكس صحيح أيضا، فالمتلقي لا يستطيع أن يملأ بالمعنى المحدد إلا العمل الذي لا يكون مطلقا. تقول الشاعرة فاطمة حدّاد:
رفعْ شَانْهَا جل جلاله
وزَادْها تمْجَادْ
يَاكْ نْبينَا وصَّى عْلِينَا
حدَّثْ وقَالْ شلاَّ كْلامْ
بَاشْ تْحَنُّوا فِينَا
رَاهْ فِينَا لمِّيمَة لحْنِينَة
والاخْت لِّي مْعَاهَا تربِّينَا
وفلْذة لكْبَادْ ضْيَا عيْنِينَا (ص. 101- 102)
وهكذا تبدو دلالة المرأة في قصيدة الزّجل دلالة متكوِّنة وفق الدّهشة المعرفية، وهذا لا يتم إلا في إطار تذوق جمالية العالم واكتشافه في أدق مستوياته، بل تخرج الشاعرة هذه العلاقة الفنية بتصور إيروتيكي مميز له مفاهيمه الخاصة عن موضوعة المرأة.
على سبيل الختم
بناءً على ما تقدم من طرح، نستطيع القول إن ديوان “السواكن المجذوبة” ينفذ إلى القلوب، ويعبر عن خلجات النفس، تتغنّى بقصائده الشاعرة فاطمة حدّاد فتثير المتعة واللذة لدى المتلقي، لما تتضمنه اللغة الإيحائية من رقّة وحلاوة. ومن ثمة، فإن اللغة الشعرية في هذا المستوى تعبيرية إيحائية تحمل هواجس الذات الناطقة بالألفاظ والعبارات الحية المعبّرة، والمعاني الخفية العميقة. وإجمالا قد حاولت الشاعرة أن تبلغ بقلبها ومشاعرها إلى ما لا يتسنَّى للعقل والحواس الوصول إليه، فاطمأنّت إلى ما جاد به ذوقها وانطوت عليه روحها من دلالات.